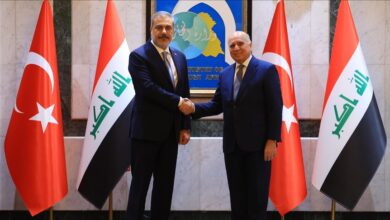سوريا ٢٠٢٥: مفاوضات السلام وسط عمليات الخطف والتطرف

بقلم إيرينا تسوكرمان
اختطاف المواطنين الأكراد في ظل حكومة الوحدة
إن الاعتقال والاختطاف الموجهين للأكراد في جميع أنحاء سوريا منتصف عام ٢٠٢٥ لا يُبرز هشاشة النظام الانتقالي في مرحلة ما بعد الأسد فحسب، بل يُبرز أيضًا استمرار ترسيخ الممارسات الأمنية التمييزية عرقيًا التي لا تزال تُقوّض مصداقية حكومة الوحدة السورية. ورغم التزامات الإدارة العلنية بالإصلاح الديمقراطي والحكم الشامل، تبدو هذه الوعود جوفاء بشكل متزايد في ضوء الأدلة المتزايدة على أن المدنيين الأكراد لا يزالون عرضة للعنف القسري، ومضايقات الدولة، وفوضى الميليشيات في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة للاحتلال.
في دمشق، قلب الحكومة المدنية الناشئة، أثار اعتقال تسعة شبان أكراد في حي الشعلان الراقي غضبًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات السياسية الكردية. احتجزت أجهزة الأمن السورية الرجال المعتقلين، الذين سافروا إلى العاصمة في زيارة قصيرة، دون أوامر اعتقال مسبقة أو توجيه تهم إليهم. وبعد أكثر من أسبوعين، لم يُصدر أي مبرر رسمي، ولا يزال مكانهم الحالي مجهولاً. يعكس هذا الصمت المتعمد اعتماد نظام الأسد الصارخ على الاختفاء القسري والاعتقال السري لقمع المعارضة السياسية، لا سيما بين الأقليات العرقية ونشطاء المجتمع المدني. وقد وجهت عائلات المعتقلين نداءات عاجلة عبر وسائل إعلام كردية ومنظمات حقوق إنسان، مطالبةً حكومة الوحدة الوطنية إما بالإفراج عن الشباب أو توفير أسس قانونية لاحتجازهم. ولا تنبع تحذيراتهم من استخدام التعذيب من جنون العظمة، بل من سابقة مؤلمة – ففي عهد الأسد، تعرض آلاف المعتقلين الأكراد للتعذيب الممنهج والاختفاء القسري أو القتل خارج نطاق القضاء في شبكة السجون المترامية الأطراف التي تديرها المخابرات. تعهدت الإدارة الانتقالية الحالية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بإصلاح المؤسسات الأمنية السورية وتفكيك إرث المراقبة والاعتقال التعسفي الذي ميّز النظام البعثي. إلا أن هذه الاعتقالات الأخيرة تشير إما إلى افتقار القيادة السياسية إلى سيطرة فعلية على الأجهزة الأمنية، أو إلى أن عناصر من النظام السابق لا تزال متغلغلة فيها، تعمل تحت ستار الشرعية الجديدة. وإذا صحّ أيٌّ من التفسيرين، فإن المضمون جليّ: لا يزال هيكل السلطة المركزية في سوريا، على الرغم من تغيير الأسماء والقيادات، يعتمد على منطق حكم قسري بدلاً من منطق قائم على القانون أو المساءلة أو الحقوق.
ومما يزيد من تفاقم هذه الأزمة موجة الاختطاف والاعتقالات خارج نطاق القضاء المستمرة في عفرين، وهي مدينة ومنطقة محيطة بها في شمال غرب سوريا تحت سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا. ففي 6 يوليو/تموز، اختطفت مخابرات إحدى هذه الفصائل شابًا كرديًا يبلغ من العمر 21 عامًا من أمام مرآب مدينة عفرين مباشرة. وقد أُخذ الرجل، الذي يعاني من مرض السكري، دون أمر قضائي أو تهمة ولم يُسمع عنه منذ ذلك الحين. وهو ينحدر من قرية هاس خليل في ناحية راجو، وهي منطقة شهدت استهدافًا متكررًا للمدنيين الأكراد من قبل ميليشيات الجيش الوطني السوري منذ التوغل العسكري التركي في عفرين عام 2018. ووفقًا لمركز توثيق الانتهاكات، فقد اختُطف ما لا يقل عن 87 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في عفرين حتى الآن في عام 2025. وتعرض العديد من الضحايا لمعاملة وحشية، مع تزايد عدد القتلى تحت التعذيب. يُحتجز آخرون في سجون مؤقتة، وغالبًا ما تُعاد فديةٌ إلى عائلاتهم بحجة “التحقيقات الأمنية”. هذه الانتهاكات ليست معزولة؛ بل تُمثل نمطًا ممنهجًا من الترهيب العرقي، ومصادرة الأراضي، والهندسة الديموغرافية المُصممة لإضعاف الوجود الكردي واستقلاله السياسي في المنطقة.
مع أن حكومة الوحدة الوطنية لا تُسيطر رسميًا على عفرين، فإن صمتها المُستمر على انتهاكات حقوق الإنسان هذه – لا سيما في سعيها للحصول على اعتراف دولي وتطبيع – يُعادل تواطؤًا ضمنيًا. علاوة على ذلك، يُثير غياب الإدانة تساؤلات حول مدى التزامها بوحدة أراضي سوريا واستعدادها لحماية مواطنيها في المناطق الخارجة عن سيطرتها اسميًا. كما يعكس الوضع الغموض الاستراتيجي للنفوذ التركي في شمال سوريا، حيث تُواصل أنقرة تمويل وتوجيه الفصائل التابعة لها، بينما تُعلن دعمها للاستقرار ومكافحة الإرهاب. هذا النفاق معروف جيدًا بين المجتمعات الكردية، التي تنظر إلى الفصائل المدعومة من تركيا على أنها امتدادات أيديولوجية لسياسة تركيا الأمنية المُعادية للأكراد. كان لتقارب هاتين الحادثتين – عمليات الاختطاف في دمشق على يد قوات الأمن المرتبطة بحكومة الوحدة، والاختطاف في عفرين على يد ميليشيا مدعومة من تركيا – تأثيرٌ مُخيف على انخراط السكان الأكراد السوريين في عملية الانتقال السياسي. فبدلاً من الشعور بالانتماء إلى إطار تعددي ما بعد الأسد، يشعر العديد من الأكراد الآن بحصارٍ مضاعف: الجمود القمعي لدمشق، والعنف غير المُحاسب للميليشيات المدعومة من تركيا. وقد أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذي تبنى حتى الآن نهجًا حذرًا تجاه حكومة الوحدة، تحذيرًا صارخًا بشأن “تصعيد أمني خطير” في الأحياء الكردية بالعاصمة. ويُبلغ ناشطون عن تصاعد في عمليات المراقبة والترهيب والاعتقالات السياسية التي تستهدف الأكراد الذين يحاولون التنظيم بشكل مستقل عن الهياكل القومية العربية. وتُهدد هذه التطورات بتمزيق ما تبقى من ثقة ضئيلة بين الفاعلين السياسيين الأكراد والسلطات الانتقالية.
إن الخطر الذي تواجهه حكومة الوحدة الوطنية ليس أخلاقيًا فحسب، بل استراتيجيًا أيضًا. فبينما تدخل في مفاوضات سلام مع إسرائيل، وتسعى للحصول على دعم من دول الخليج وأوروبا، وربما الولايات المتحدة، عليها أن تثبت قدرتها على الحكم بشرعية، وفرض حماية المدنيين، وتفكيك العنف الطائفي والعرقي الذي ميّز الحرب الأهلية السورية. إن استمرار الصمت – أو الأسوأ من ذلك، التسامح السلبي – تجاه الاضطهاد الكردي يُقوّض هذا الادعاء، ويُعرّض الحكومة لاتهامات بالنفاق. بالنسبة للوسطاء الدوليين، فإن السؤال المطروح الآن هو: هل يدعمون نظامًا ديمقراطيًا جديدًا أم يُعيدون صياغة الوضع الراهن الاستبدادي؟
في نهاية المطاف، يُمثّل اختطاف واضطهاد المواطنين الأكراد في جميع أنحاء سوريا اختبارًا حاسمًا لحكومة الوحدة الوطنية. وسواء استجابت بشفافية ومساءلة قانونية وإصلاحات مؤسسية – أو لجأت إلى الصمت والإفلات من العقاب – سيُحدّد ما إذا كان الانتقال السوري الموعود منذ فترة طويلة سيبقى قابلاً للاستمرار أم سينهار في مرحلة أخرى من الصراع مُغطّاة بعباءة السلام. رفع الولايات المتحدة للعقوبات عن هيئة تحرير الشام وسط مخاوف مستمرة بشأن حقوق الإنسان
أثار قرار الحكومة الأمريكية في منتصف عام 2025 برفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، على الرغم من الشكوك الواسعة حول تورطها في انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاختطاف القسري والاعتقالات التعسفية، جدلاً وارتباكاً كبيرين بين المحللين ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الإقليمية. لطالما ارتبطت هيئة تحرير الشام، وهي فصيل جهادي مهيمن يسيطر على مساحات شاسعة من شمال غرب سوريا، وخاصة في محافظة إدلب، بأيديولوجية متطرفة وانتهاكات موثقة ضد السكان المدنيين. لذا، يمثل هذا التخفيف للعقوبات تحولاً بارزاً في السياسة الأمريكية، ويثير تساؤلات جوهرية حول الحسابات الاستراتيجية التي يقوم عليها نهج واشنطن تجاه الصراع السوري ومشهد مكافحة الإرهاب الأوسع.
يبدو أن عدة عوامل متشابكة قد أثرت على قرار الحكومة الأمريكية برفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام. ومن أهم هذه العوامل البيئة الجيوسياسية والتكتيكية المتطورة في سوريا. مع توسّع سيطرة نظام الأسد في مناطق أخرى، ومع ظهور حكومة الوحدة السورية التي تسعى إلى استقرار محدود، لا تزال هيئة تحرير الشام إحدى الجماعات القليلة القادرة على ممارسة حكم محلي فعال وسيطرة أمنية على مراكز سكانية مهمة في شمال غرب سوريا. في ظل غياب بدائل مجدية، يبدو أن الولايات المتحدة قد أعادت ضبط سياستها لاستيعاب إطار عمل عملي يُعطي الأولوية لخفض التصعيد ووصول المساعدات الإنسانية على حساب النقاء الأيديولوجي. يتماشى هذا التحول مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية الأوسع نطاقًا، والتي تهدف إلى تقليل التدخل العسكري المباشر مع الحفاظ على النفوذ من خلال القنوات الدبلوماسية ووسطاء السلطة المحليين.
عاملٌ آخر يُسهم في ذلك هو شبكة التحالفات والتنافسات المحلية المتزايدة التعقيد والتقلب في شمال غرب سوريا. فقد تطورت هيئة تحرير الشام من تمرد جهادي صريح إلى جهة فاعلة أكثر تهجينًا تجمع بين السيطرة المسلحة والوظائف الإدارية، بما في ذلك إنفاذ القانون والأنشطة القضائية وتوفير الخدمات الأساسية. ورغم أن هذا لم يُلغِ تاريخها الحافل بالعنف المتطرف وانتهاكات حقوق الإنسان – بما في ذلك عمليات الاختطاف والاختفاء القسري وقمع المعارضة السياسية – إلا أنه جعلها سلطةً فعليةً يُهدد استبعادها من أي مشاركة سياسية أو إنسانية بمزيد من زعزعة الاستقرار وزيادة معاناة السكان المدنيين. ويبدو أن الولايات المتحدة قد حسبت أن الإبقاء على العقوبات على هيئة تحرير الشام قد يُعيق جهود التفاوض على الممرات الإنسانية، وإيصال المساعدات، والحد من العنف، لا سيما وأن رعاية تركيا للفصائل المرتبطة بها تُعقّد التدخل المباشر. علاوةً على ذلك، قد يعكس رفع العقوبات رغبة واشنطن في إعادة تقييم سياستها تجاه سوريا بالتنسيق مع الجهات الإقليمية الحليفة، وخاصة تركيا ودول الخليج، التي سعت إلى إعادة دمج أجزاء من شمال غرب سوريا في تسوية سياسية مُحكمة. لا يمكن إغفال العلاقة الغامضة لهيئة تحرير الشام مع الميليشيات المدعومة من تركيا وأهميتها الاستراتيجية في الحفاظ على توازن القوى في المنطقة. وبهذا المعنى، يُعدّ تخفيف العقوبات أداة دبلوماسية بقدر ما هو انعكاس لتغير الأولويات على الأرض. ومن خلال تخفيف القيود الاقتصادية والقانونية على هيئة تحرير الشام، قد تُشير الولايات المتحدة إلى قبول ضمني لدورها كوسيط محلي للسلطة، بينما تحاول احتواء عناصرها الأكثر تطرفًا من خلال التأثير غير المباشر.
ومع ذلك، والأهم من ذلك، أن هذا التعديل في السياسة جاء على حساب اعتبارات حقوق الإنسان. فعلى الرغم من التوثيق الواسع من قِبَل منظمات مثل مركز توثيق الانتهاكات (VDC) وهيئات الرقابة الدولية بشأن عمليات الاختطاف والتعذيب والقمع المرتبطة بهيئة تحرير الشام – وهي ممارسات تُفاقم معاناة المدنيين وتُعيق آفاق المصالحة الحقيقية – اختارت الحكومة الأمريكية التقليل من شأن هذه المخاوف أو حصرها في إطار ضيق. ويعكس هذا القرار إعطاء الأولوية الواقعية السياسية للاستقرار قصير المدى والتموضع الجيوسياسي على الالتزامات المبدئية بحقوق الإنسان والعدالة. ومن شأن هذا الموقف أن يشجع هيئة تحرير الشام والجهات الفاعلة المماثلة، مما قد يسمح باستمرار الانتهاكات دون رادع تحت ستار الحفاظ على النظام.
إن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يُرسل رسالةً مُعقدةً إلى المجتمع الكردي السوري والأقليات الأخرى التي عانت بشكلٍ غير متناسبٍ من العنف التعسفي للجماعات المسلحة. كما يُثير شكوكًا حول موثوقية وتماسك أطر الحماية الدولية للفئات السكانية الضعيفة، ويُقوّض الثقة في عملية السلام الأوسع. إذا بدت الولايات المتحدة، وهي جهة فاعلة رئيسية في تشكيل المشهد السوري لما بعد الصراع، على استعدادٍ لتطبيع العلاقات مع جماعةٍ متورطةٍ في انتهاكاتٍ جسيمة، فإن ذلك يُلقي بظلاله على شرعية الحكومة الانتقالية والجهود الدبلوماسية الدولية ككل.
يعكس قرار إدارة ترامب برفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، على الرغم من الشكوك المستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان، موازنةً مُحفوفةً بالمخاطر بين الضرورات الاستراتيجية المتنافسة. وبينما قد يُسهّل ذلك المرونة التشغيلية على المدى القصير والتفاعل مع الجهات الفاعلة المحلية، إلا أنه يُخاطر بتعريض الأهداف طويلة المدى المتمثلة في العدالة والمساءلة والحوكمة الشاملة في سوريا للخطر. من المرجح أن تتردد أصداء عواقب هذه السياسة في جميع أنحاء المنطقة، مؤثرةً على مسار الصراع وآفاق تسوية سياسية مستدامة تحترم الحقوق.
محادثات هنغبي – الشرع في أبوظبي: عملية دبلوماسية متواصلة
بحلول منتصف عام 2025، مثّلت سلسلة اللقاءات الدبلوماسية المستمرة بين أحمد الشرع، رئيس حكومة الوحدة الوطنية السورية في مرحلة ما بعد الأسد، ووزيرة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، تسيبي هنغبي، والتي عُقدت بشكل رئيسي في أبوظبي، تطورًا هامًا في المساعي المعقدة للتقارب السوري الإسرائيلي. وبدلاً من أن تكون هذه المحادثات حدثًا واحدًا، فإنها تمثل عملية دبلوماسية مستدامة ومتقدمة بحذر، تهدف إلى كسر عقود من العداء المتجذر وبناء أطر للتعايش والتعاون المحتملين.
برزت أبوظبي كمكان رئيسي لهذا الحوار، وقد اختيرت لحيادها الاستراتيجي ودورها المتنامي كمركز دبلوماسي إقليمي. يعكس انخراط الإمارات العربية المتحدة – وعلى نطاق أوسع، مجلس التعاون الخليجي – إعادة تقييم إقليمية نحو انخراط براغماتي مع السلطات الانتقالية السورية. وقد انتقلت دول الخليج، الحريصة على احتواء النفوذ الإيراني وتحقيق الاستقرار في محيطها، تدريجيًا من العزلة إلى تعزيز الحوار، مما يشير إلى ديناميكية جيوسياسية جديدة تشجع على حوارات مستدامة بين خلفاء دمشق وإسرائيل.
دارت المحادثات الجارية حول جدول أعمال أساسي يشمل إرساء آليات لوقف إطلاق النار على طول الحدود المتنازع عليها، والتفاوض على تبادل الأسرى، وبحث التنسيق الأمني، ومعالجة مخاوف مكافحة الإرهاب. وقد أعرب الطرفان مرارًا وتكرارًا عن إدراكهما لانعدام الثقة المتجذر والقضايا العالقة – مثل وضع مرتفعات الجولان والسيطرة المجزأة على الأراضي السورية – التي تُعقّد عملية السلام. ومع ذلك، فإن استمرار الحوار في حد ذاته يعكس اعترافًا متبادلًا بالحاجة إلى بناء ثقة تدريجيًا خطوة بخطوة.
تمحور دور تسيبي هنغبي حول توضيح الضرورات الأمنية الإسرائيلية، مع التركيز على منع التغلغل الإيراني والحد من نشاط الميليشيات المعادية قرب الحدود الإسرائيلية. وتشمل ولايته الحالية ضمان التزامات من حكومة الوحدة السورية بأن هياكل الحكم المستقبلية لن تسمح بعودة الجماعات المتطرفة المسلحة. من ناحية أخرى، سعى أحمد الشرع إلى وضع الحكومة الانتقالية كجهة فاعلة موثوقة ومعتدلة قادرة على تحقيق الاستقرار في سوريا والتواصل بشكل بناء مع أصحاب المصلحة الإقليميين لتسهيل إعادة الإعمار واستعادة السيادة. على الرغم من هذا الزخم، لا تزال العديد من التحديات المستمرة تعيق التقدم. لا تزال سلطة حكومة الوحدة السورية هشة، ومتنازع عليها داخليًا من قبل الموالين للنظام والفصائل الكردية والجماعات الإسلامية، وخارجيًا من قبل القوى الإقليمية المتنافسة. ويشكل استمرار وجود ونشاط الجماعات المسلحة – مثل هيئة تحرير الشام في إدلب والميليشيات المدعومة من تركيا في الشمال الغربي – عقبات خطيرة أمام إرساء ترتيبات آمنة وقابلة للتنفيذ. وتضيف المظالم الكردية، التي أكدتها عمليات الاختطاف والقمع الأخيرة، مزيدًا من التعقيد أمام تحقيق تسوية سياسية شاملة. وفي الوقت نفسه، يرسم المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل معالم هذه المحادثات. وتواجه جهود هنغبي شكوكًا داخل الدوائر الأمنية الإسرائيلية بشأن جدوى أي محاور سوري، لا سيما إذا كان ينبثق من حكومة انتقالية ذات سيطرة إقليمية محدودة وتحالف غير مستقر من الفصائل المسلحة. ومع ذلك، فإن اتجاهات التطبيع الأوسع بين إسرائيل ومختلف الدول العربية قد خلقت فرصًا دبلوماسية جديدة، مما يجعل احتمال الحوار السوري الإسرائيلي أكثر قابلية للتطبيق مما كان عليه في العقود السابقة.
تُشكل هذه العملية الدبلوماسية المُستدامة، التي تُركز في أبوظبي، جهدًا مبدئيًا، وإن كان ذا طابع تحويلي، لإعادة تشكيل الديناميكيات الإقليمية. ويعتمد النجاح على التغلب على انعدام الثقة المُتجذر، ومعالجة التحديات الإنسانية والأمنية بشكل شامل، والتوصل إلى اتفاق مرن بما يكفي لتحمل التشرذم السوري الداخلي والتنافسات الجيوسياسية الخارجية. وبينما يستمر الحوار، يظل مُخيمًا عليه العنف المُستمر وعدم اليقين السياسي، مما يعكس هشاشة وضرورة هذا الجهد المُضني من أجل السلام.
العلاقة بين تقدم محادثات سوريا واجتماع نتنياهو-ترامب المُحتمل
مهد العشاء الأخير في واشنطن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب الطريق لتنسيق إسرائيلي-أمريكي أوثق بشأن سوريا، لكن الاختبار الحقيقي يكمن في اجتماع مُحتمل للمتابعة قد يُؤثر بشكل حاسم على مسار محادثات السلام.
يعتمد التقدم في محادثات سوريا، التي يقودها أحمد الشرع وتسيبي هنغبي في أبوظبي، بشكل كبير على استمرار المشاركة السياسية رفيعة المستوى. أرسى العشاء الأول أساسًا من الثقة والتفاهم المتبادل، إلا أنه ترك العديد من القضايا الاستراتيجية دون حل، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الترتيبات الأمنية وآليات الحد من وكلاء إيران والميليشيات المتطرفة داخل سوريا.
يُنظر على نطاق واسع من قبل المطلعين على بواطن الأمور إلى عقد اجتماع متابعة بين نتنياهو وترامب باعتباره ضروريًا لترجمة حسن النية من لقائهما الأول إلى توجيهات سياسية ملموسة والتزامات بتوفير الموارد. يمكن لمثل هذا الاجتماع أن يوضح دعم الولايات المتحدة لمطالب إسرائيل الأمنية، ويهيئ شروط مساعدات إعادة الإعمار للحكومة الانتقالية السورية، وينسق الرسائل الإسرائيلية الأمريكية تجاه اللاعبين الإقليميين مثل تركيا وروسيا ودول الخليج.
بدون هذه القمة القادمة، هناك خطر من أن الزخم الناتج عن عشاء واشنطن قد يتوقف في ظل الانقسام الداخلي السوري والعنف المستمر، مما يقوض التقدم الهش المحرز في أبوظبي. علاوة على ذلك، يمكن أن يُسهم اجتماع متابعة في تنسيق الضغط المشترك على حكومة الوحدة الوطنية السورية لكبح جماح الجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الاختطاف الأخيرة وانتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة المخاوف الإسرائيلية بشأن صدق واستدامة أي اتفاق سلام.
مع ذلك، فإن الحسابات السياسية معقدة. يواجه الزعيمان ضغوطًا داخلية قد تُؤخر أو تُحد من قدرتهما على مواصلة الانخراط في المدى القريب. قد تُحوّل سياسات نتنياهو الائتلافية وأولويات ترامب الاستراتيجية الأوسع نطاقًا التركيز بعيدًا عن سوريا، مما يُسبب حالة من عدم اليقين للمفاوضين على الأرض. يرتبط مستقبل محادثات سوريا ارتباطًا وثيقًا بمدى قدرة نتنياهو وترامب على الاجتماع مجددًا بسرعة لترسيخ رؤيتهما المشتركة وترجمتها إلى دعم عملي. تُواجه عملية أبوظبي خطر فقدان زخمها بدون هذا التعزيز السياسي، مما يُبرز كيف تعتمد جهود السلام على أعلى مستويات التنسيق الإسرائيلي الأمريكي في سياق إقليمي مُتقلب.
الثقة والمخاطر في الضمانات الأمنية
لا تزال قدرة إسرائيل على الاعتماد على الضمانات الأمنية التي قدمها أحمد الشرع، وعلى الالتزام الأمريكي المستمر، في ظل الموجة المقلقة من انتهاكات حقوق الإنسان وتجدد التطرف في سوريا، غامضة ومحفوفة بالمخاطر.
تواجه حكومة الوحدة السورية بقيادة الشرع تحديات هائلة في فرض سيطرتها الفعلية على الأراضي المجزأة، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية الكردية مثل عفرين، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة حيث تعمل الميليشيات المدعومة من تركيا وغيرها من الجماعات المسلحة باستقلالية نسبية. إن عمليات الاختطاف الموثقة والاعتقالات التعسفية وتقارير التعذيب المنسوبة إلى قوات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة الانتقالية، تقوض بشدة مصداقية أي ضمانات أمنية تقدمها. وتشير هذه الانتهاكات ليس فقط إلى ضعف القيادة والسيطرة، بل أيضًا إلى استمرار وجود العناصر المتطرفة والميليشيات التي تعمل خارج نطاق الرقابة الرسمية. هذا الواقع يُعقّد حسابات إسرائيل، إذ قد تكون الضمانات من جانب الشرع مُجدية سياسياً، لكنها تفتقر إلى التنفيذ العملي اللازم لمنع وقوع حوادث مُزعزعة للاستقرار في المستقبل.
من الجانب الأمريكي، ورغم تجديد الرئيس ترامب التزامه ودعمه المُعلن لمحادثات السلام، فإن الالتزام الأمريكي يواجه قيوداً هيكلية وسياسية. لا تزال الإدارة الأمريكية حذرة من الانخراط بشكل أعمق في الديناميكيات الداخلية لسوريا، لا سيما في ظل تشكك الكونغرس وتضارب الأولويات العالمية. وبينما قد تدعم واشنطن المصالح الأمنية لإسرائيل خطابياً ومن خلال التعاون الاستخباراتي، فإن قدرتها واستعدادها لفرض العقوبات أو الضغط على الميليشيات التابعة لها لوقف الانتهاكات مُقيّدان. ويزيد رفع العقوبات مؤخراً عن الجماعات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان من تعقيد الصورة، مما يثير تساؤلات حول تماسك السياسة الأمريكية وتأثيرها على الردع. علاوة على ذلك، فإن الارتفاع الموثق في عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية والمعاملة الوحشية للمدنيين – بمن فيهم الفئات الضعيفة مثل الشباب والنساء الأكراد – يُشير إلى عودة محتملة للتكتيكات المتطرفة التي غذّت تاريخيًا دورات العنف في سوريا. بالنسبة لإسرائيل، التي تعتبر أي عودة لنشاط الجهاديين أو الميليشيات بالوكالة قرب حدودها تهديدًا وجوديًا، فإن هذه الاتجاهات تُلقي بظلال من الشك على استدامة عملية السلام في ظل الظروف الحالية.
في جوهرها، يجب أن يُخفف من ثقة إسرائيل في الضمانات الأمنية التي قدمتها الشرع إدراكها أنه بدون سيطرة ملموسة وقابلة للتحقق على جميع الفصائل المسلحة وآليات إنفاذ أمريكية فعالة، فإن مثل هذه الوعود قد تظل طموحة. إن التقاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمشهد السياسي والعسكري الهش في سوريا يعني أن احتمالات وجود بيئة مستقرة وخالية من التطرف لا تزال هشة. ومن المرجح أن تُركز حسابات إسرائيل الاستراتيجية على المشاركة الحذرة، مطالبةً باتخاذ إجراءات مراقبة وتحقق قوية إلى جانب الجهود الدبلوماسية، مع الحفاظ على الاستعداد للطوارئ في حال تدهور الوضع. وفي نهاية المطاف، فإن نجاح عملية السلام يتوقف على تحويل حكومة الشرع من سلطة انتقالية هشة إلى ضامن موثوق للأمن، بدعم من التزام الولايات المتحدة الثابت والمتسق ــ وهو مسار صعب وغير مؤكد في ضوء الحقائق الحالية على الأرض.